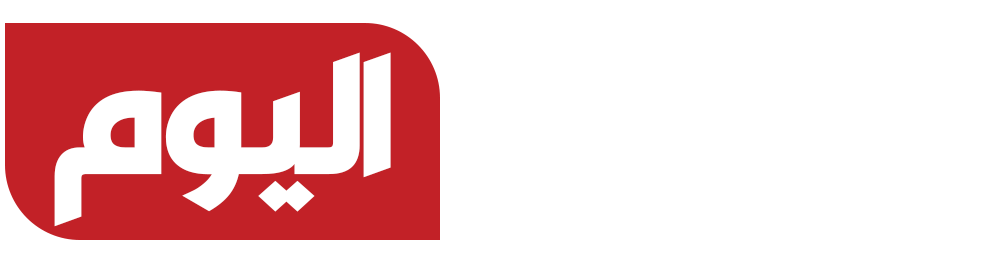كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت ضمن كتاب “استعادة الروابط”، أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، بالتزامن مع العزلة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، قد أعادا تشكيل مسار نمو المراهقين بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور ما يمكن وصفه بـ”جيل قلق” يعيش في بيئة يسودها الخوف وعدم اليقين.
وحذرت مؤلفة الكتاب، الباحثة والكاتبة الأمريكية آمبر تشاندلر، من أن هذا التحول ليس عابراً، بل ترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الشباب، داعية إلى تدخل عاجل من قبل الأسر والمدارس لمواجهة ما تعتبره أزمة متفاقمة في الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين. ومع ذلك، أكدت أن الفرصة لا تزال متاحة لتصحيح المسار من خلال تضافر الجهود لإعادة بناء الروابط الإنسانية وتعزيز الشعور بالانتماء والدعم في البيئات التعليمية والأسرية.
جيل قلق: تأثير التكنولوجيا والجائحة على نمو المراهقين
تشير تشاندلر إلى أن المراهقين اليوم يعانون من مستويات قلق غير مسبوقة، ناجمة عن تفاعل عاملين رئيسيين: العزلة الاجتماعية التي فرضها الإغلاق أثناء الجائحة، والطبيعة الإدمانية للتجارب الرقمية التي ترسخت خلال تلك الفترة واستمرت بعدها. وقد أدت التجارب الإلكترونية، التي كانت بمثابة ملاذ وحيد للتواصل خلال الإغلاق، إلى اعتماد مفرط على الشاشات، مما تسبب في تغييرات عصبية وسلوكية لدى الشباب. تصف تشاندلر هذا الوضع بأنه “كيمياء متهورة” نتجت عن مزج العزلة بالجاذبية القوية للتقنيات الرقمية.
وتؤكد الباحثة أن الحلول لا تتطلب إجراءات معقدة، بل تحتاج إلى قرارات “شجاعة” من “البالغين في البيت”. من بين التوصيات التي قدمتها تشاندلر منع استخدام الهواتف وقت النوم، وإنشاء مساحات عامة خالية من التكنولوجيا، وتأجيل إدخال الهواتف الذكية للأطفال لأطول فترة ممكنة، وتشجيعهم على حل مشكلاتهم بأنفسهم بدلًا من تدخل الأهل الدائم. كما تحث الآباء على أن يكونوا أكثر حضوراً في اللحظة الراهنة، وألا ينشغلوا بهواتفهم أثناء التفاعل مع أبنائهم، معتبرة أن القدوة تبدأ من السلوك اليومي للوالدين.
تربط تشاندلر القلق المتزايد بين المراهقين بالآثار النفسية المستمرة للجائحة، مشيرة إلى ما تسميه “إرهاق الجائحة”، حيث يشعر الكثير من البالغين بالتعب من الحديث عن تداعياتها، مما يصعب الاعتراف بعمق تأثيرها. ومع ذلك، ترى أن الصدمة تركت “أثراً جسدياً ونفسياً لا يمكن تجاهله”، ويتجلى اليوم في الفصول الدراسية وسلوكيات الشباب.
مسؤولية مشتركة: الأسر والمدارس في مواجهة التحديات الرقمية
لا تقتصر المسؤولية، بحسب تشاندلر، على الأسر وحدها، بل تمتد إلى المدارس التي زاد اعتمادها على الشاشات في التعليم والتقييم. ورغم تأكيدها أنها ليست معادية للتكنولوجيا، تعبر عن قلقها من “هوس جمع البيانات” الذي يؤدي، بحسب رأيها، إلى التركيز على التصحيح المستمر بدلًا من تعزيز الاكتشاف والإبداع والتعاون، خاصة في المراحل العمرية المبكرة.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف عالمياً بشأن تأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الشباب. وقد أقدمت أستراليا مؤخرًا على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، فيما تدرس دول أخرى سياسات مماثلة. تدعو تشاندلر في ختام طرحها إلى الجمع بين التعاطف والمساءلة، مؤكدة أن الكثير من الآباء لم يكونوا يدركون الطبيعة الإدمانية للتقنيات الحديثة، لكنها تشدد على ضرورة تحمل العائلات مسؤوليتها، قائلة إن الأطفال لم يشتروا هذه الأجهزة بأنفسهم، بل قُدمت لهم من الكبار.
ترى تشاندلر أن إعادة بناء الروابط الإنسانية، وتعزيز الأنشطة الوجاهية، وتعليم الشباب كيفية التعامل الواعي مع التكنولوجيا، تمثل خطوات أساسية نحو استعادة التوازن في عالم باتت فيه الشاشات جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. يبقى التحدي القادم هو كيفية تطبيق هذه التوصيات على نطاق واسع، مع استمرار تطور التكنولوجيا وتأثيرها المتنامي على حياة الأجيال القادمة، وسط عدم اليقين بشأن الاستجابة المجتمعية الشاملة لهذه الأزمة.