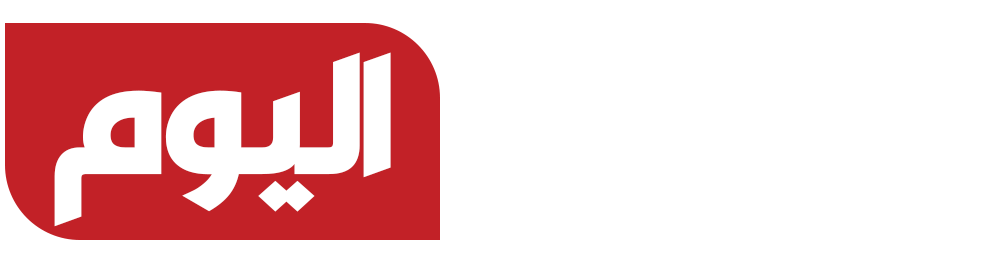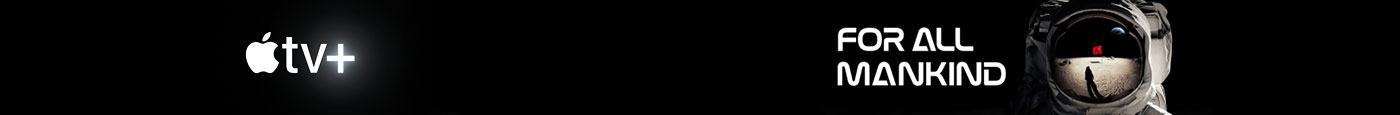يعرض فيلم “إسرائيل: فلسطين ستون سنة من العنف” للمخرج “ماتيو شوارتز” على نحو ما، المراحل الكبرى من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فيبدأ من عام 1948 تاريخ النكبة بإعلان قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
ويستحضر في سرد تاريخي، يكاد يخلو من البعد التحليلي، ما يشير إليه بعقود من العنف والكراهية. ويورد وفق الموارد البصرية المعروضة التمييز والتهجير القسري الذي تعرض له الفلسطينيون. ومأتى أهمية الفيلم من “موضوعيته”، الظاهرة على الأقل ومن تجسيده للتصور الغربي للصراع العربي الإسرائيلي. ففي طبقاته العميقة تفسير لمواقف الساسة والمفكرين من القضية الفلسطينية ومن الاحتلال الإسرائيلي.
النكسة.. يوم انقلبت الطاولة على العرب
يمدّنا الفيلم بمعلومات تاريخية كثيرة، ولكنّ أغلبها يعدّ من معارفنا البديهية شأن ما تعرّض له الأهالي من تهجير شمل 700 ألف عربي (أو 800 ألف وفق المصادر التاريخية الإسرائيلية نفسها) ومطاردة الجيوش الصهيونية لأفواج النازحين ليتجمّعوا في مخيمات بالأردن أو بيروت أو غيرهما وليتحوّلوا إلى شعب مقيم في المنافي بات أهله يعرفون بفلسطينيي الشتات (وهي التسمية التي كانت تطلق على اليهود).
ثم يعرض حلم العودة الذي أخذ يتبدّد شيئا فشيئا ويتحوّل إلى ملاذ يستعين به المهجّرون للحدّ من قسوة واقعهم. فقد كانت العائلات تعتقد أنها لن تغادر إلا لفترة وأنها ستعود إلى ديارها بعد استقرار الوضع الأمني والعسكري، وما كان يغذّي هذا الحلم تحالفُ الجيوش العربية الذي دعا إليه جمال عبد الناصر لتحرير فلسطين وإنهاء وجود إسرائيل.
وخلافا للتوقّع، كانت إسرائيل هي المبادرة بالهجوم في يونيو/حزيران 1967، فساعدها عنصر المفاجأة على تدمير أغلب الطيران المصري في مرابضه وعلى تحقيق انتصار مدوّ جعلها تتوسع، فتحتل غزة والضفّة والجولان وسيناء وتضاعف مساحتها 4 مرات، وجعلها تستحقّ إطراء “شارل ديغول” بأن وصفها بكونها شعبا من النخب واثقا من نفسه مهيمنا [على جيرانه].

في هذا السياق ستظهر حركة فتح لتقود نضالات الفلسطينيين وستمنحها معركة مخيم الكرامة في الأردن الشرعية التي ستخوّل لها قيادة منظمة التحرير لاحقا، وستنوّع المقاومة من أساليبها بين الهجمات على خطوط المواجهة والتفجيرات واختطاف الطائرات.
وكانت ترمي من وراء ذلك إلى ترك ملف القضية الفلسطينية مفتوحا فلا يركن في رفوف الهيئات الدولية وإلى مبادلة الأسرى والمعتقلين، ولكن ستمثّل زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل نقطة التحول الأوّل الكبير في هذا الصراع، ثم سيمثّل طرد الفلسطينيين من لبنان نحو تونس في 1982 بعد أن طردوا قبلئذ من الأردن التحوّل الثاني الكبير.
حماس.. الظهور الحتمي لغياب فتح
ثم يعرض الفيلم الطّور المعاصر من هذا الصّراع، فقد بدأ بظهور حركة حماس إثر الانتفاضة الفلسطينية الأولى وانتهى بفشل مفاوضات السلام إثر اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، وانقسام الفلسطينيين إلى سلطة فتحاوية في الضفّة وأخرى حمساوية في غزّة. ويشير ضمنا إلى أنّ حماس التي تمثّل الإسلام الرّاديكالي تتحمّل المسؤولة المباشرة عن تدمير مسار السّلام.

ورغم أنّ هذه المعلومات تبدو لنا بديهية، ورغم أنّ دقّة بعضها يظل مثيرا للاحتراز، يبقى الفيلم على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلى المتقبل الغربي الذي تستهدفه مادته والذي لا يعرف الكثير عن حقيقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فكان درسا في التاريخ لا يخلو من ثغرات كما سنبيّن لاحقا.
خمس شخصيات تجسد الصراع
تتوافر في الفيلم مقوّمات الدراسة الوثائقية الكلاسيكية المختلفة، من وصف للواقع يفصّل حياة البؤس في المخيمات الفلسطينية وعرض للوقائع وتحديد للأسباب وتفصيل للنتائج.
وحتى يجعلنا الفيلم نعايش هذا الصّراع، فإنه يقدّمه من خلال تتبّع مصائر خمس شخصيات مختلفة يجدها ممثّلة لمختلف وجهات النّظر حول هذا الصراع.
فمن الفلسطينيين يعرض شخصية صلاح الثامري الذي يعرفنا على هول صدمة حرب الأيام الخمسة كما عاشها بعد انتشار الأخبار الزائفة التي كانت تروّج عن الانتصار العربي الساحق سنة 1967 ليكتشف بعدئذ حقيقة الهزيمة النكراء في الإذاعة البريطانية ثم لينخرط بدوره في القتال ضد إسرائيل ويقوم بالتسلّل إلى عمقها ليستهدف جيشها.

ويعرض تجربة المصور الحربي الفلسطيني عبد السلام شحادة (والمخرج السّينمائي لاحقا) ليصف لنا غزو رفح والتهجير القسري وما خلّفته من الفوضى. ثم يعرّفنا على ليلى خالد المعلمة المقيمة بالمخيمات الفلسطينية بلبنان، والتي يدفعها حلمها بالعودة إلى الانخراط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثم سيحولها إلى قرصان جوي، ويفصّل كيفية استقطابها لاختطاف الطائرات بداية من الطّائرة الإسرائيلية التي أقلعت من لوس أنجلوس باتجاه تل أبيب في أغسطس/آب 1969 وكان من المفترض أن يكون إسحاق رابين على متنها. فيكون الصيد الثمين الذي يتمّ عبره لفت النّظر إلى القضية الفلسطينية ولكن طرأ ما جعله يغير رحلته فجأة.
ومن الجانب الإسرائيلي يعرض لنا سيرة “يوري هيرفيتز” الضابط بجيش الاحتياط الإسرائيلي الذي ولد في “كفر غيلادي” حيث أقام والده الفارّ من روسيا والنّاجي من المذابح ضد اليهود، مبرزا نخوته بما فعله والده من ترسيخ للوجود اليهودي وتأسيسه لقرية “كفر غيلادي” بعد أن كانت مجموعة من المخيمات يقيم فيها الوافدون من أوروبا الشرقية، أو إسهامه هو في تأمين سلامة الطيران الإسرائيلي بعد عمليات الاختطاف التي نفّذها الفلسطينيون.

وفي الآن نفسه يعرض سيرة “ياريف هوروويتز” السينمائي الشاب الذي يرث عن أمه أفكارها اليسارية فيتظاهر ضد تورّط إسرائيل في مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت ويفضح جرائم الجيش الإسرائيلي في تعامله مع أطفال الحجارة، وذلك عوضا عن تصوير فيلم دعائي كان يريده رؤساؤه في الجيش لمّا دعي لواجب الجندية. ولكنه مع ذلك ورغم كلّ الهول الذي يرتكب ضدّ المدنيين، يظلّ يتوجّس من فظاظة العرب مؤمنا بأخلاقية الجيش الإسرائيلي.
فكانت هذه الشخصيات الفلسطينية تعكس إحباط المهزومين بقدر ما كانت الشخصيات الإسرائيلية تعكس احتفاء المنتصرين.
حين يتحدث الغربي عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يحاول الفيلم أن يعتمد مقاربة صارمة تصدر عن الوثائق والفيديوهات والحقائق التاريخية وتحاول عرض وجهات نظر مختلف الأطراف، بحيث يدعو المخرج المتفرّج إلى الحكم بحرية دون أن يتورّط في تقديم الموقف الخاص بشأن صراع معقّد.
ولكن ليس ما نذكر غير ظاهر خادع، فحينما نمعن النّظر في المادة المقدّمة ورغم الإقرار بصحتها تاريخيا لا بدّ أن نسجّل الاحترازات الكثيرة التي تصيب الموضوعية في مقتل. فالفيلم يغرق في الجانب الوصفي ويعرض مادة منتقاة من وقائع وتفصيلات عديدة جدا، ولكن أن ينتقي تفجيرات من هذا الطّرف وهجمات من ذاك باسم التوازن في المقاربة، فذلك يوحي بتكافؤ الصّراع والحال أن الجيش الإسرائيلي المدعوم من قبل الدّول الغربية العظمى يواجه مدنيين عزّل لا حول لهم ولا قوّة.

فالأرقام تؤكّد ذلك، إذ منذ عام 1948 قتل 30 فلسطينيا مقابل قتل الإسرائيلي الواحد. والعنوان الذي ينص على ستين سنة من العنف يؤكّد هذه المساواة بين المعتدي والضحية بحجة الحياد.
فضلا عن ذلك جاء الفيلم تبسيطيا بشكل مخل ومحرّفا للحقائق، فمحنة الفلسطينيين واعتداء الصهاينة لم يبدآ فجأة في 14 مايو/أيار 1948، وتقديمها على هذا الأساس يجعل من الإسرائيليين أصحاب حقّ ويصوّر عدوانهم في شكل دفاع عن وجودهم المشروع في أرض فلسطين.
والحال أنّ هذا الوجود قد تم التمهيد له قبل أكثر من ستين سنة من الهجرة اليهودية المنظّمة من روسيا وأوروبا الشرقية ومن التواطؤ البريطاني الذي وعد اليهود بأرض فلسطين ونفّذ وعده، فسلمهم دولة جاهزة قائمة منذ مئات السنين، وسهّل لهم الاستيلاء على مؤسساتها.
إذن لا يكمن معنى الأفلام في عرض المواد التاريخية وإنما في كيفية عرضها وفي كيفية الربط بينها على مستوى المونتاج، وفيلم الحال يبدأ بإعلان قيام دولة إسرائيل. وبعد هذه المشاهد مباشرة يعرض تنكيل هتلر باليهود، والحدثان يعدّان من الحقائق التاريخية، ما في ذلك شكّ.
لكن المجاورة بينهما عن طريق المونتاج يدفع إلى الاعتقاد بأن سلب الفلسطينيين أرضهم ودولتهم هو رفع للمظلمة المسلطة على اليهود، مما يعدّ تزييفا للحقائق وتلاعبا بالأذهان.
ما غفل عنه الفيلم
يبدأ الفيلم بتعرض اليهود للتطرّف النازي وينتهي بهجمات حماس، ممّا يرسّخ فكرة اليهودي المهدّد دائما الذي يتعيّن عليه أن يقاتل لكي ينعم بحقه في الأمن. وهذا ما يعدّ تبريرا ضمنيا لكل ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين.
وعلى هذا النّحو خاض المخرج في هذا العنف “المشترك” دون أن يكلّف نفسه عناء البحث في جذوره العميقة. فقد ألقى باللائمة ضمنا على الإسلام الراديكالي الذي يحول دون تحقيق السلام، دون أن يشير إلى الخلفيات العقدية اليهودية المكبلة لكل سلام ممكن.
فالعقيدة اليهودية فاعلة بقوة في تحديد السياسة الإسرائيلية، وعلى نبوءاتها تأسست دولة إسرائيل ومدارها على أنّ الله سيجعلهم مباركين وسط الأمم المتعددة، فيعطيهم أرض كنعان وما جاورها ويجعلها ملكا أبديا لهم، وعلى أنّ الأرض المقدسة ستكون في آخر الزمان تحت سلطتهم، مقابل عبادته والتزامهم بتعاليمه.
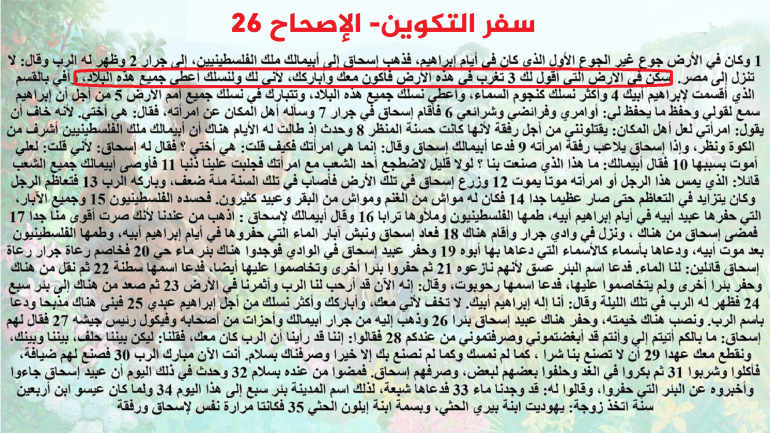
ومن نبوءات التلمود في كتاب “الزوهارورد” أن العرب سيمنعون اليهود من دخول المكان المقدس الذي يؤوي الهيكل، ويبشرهم مع ذلك، بأنه سيسخرهم لبناء إسرائيل بأيديهم لفائدتهم.
جاء في سفر التكوين، الإصحاح 26 “فأجاب إسحاق وقال لعيسى (ابنه) إني قد جعلته سيدا لك، (يقصد يعقوبَ) ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا، وعضدته بحنطة وخمر فماذا أصنع لك يا بني؟”.
وتربط نبوءاتهم انتهاء الشتات ومَقدم المسيح المنقذ بتشتيت العرب وتخريب أراضيهم. فمن نبوءات الحاخام أليعازر (منذ 2000 سنة) وبعل هاتوريم (1500عام) أن نسل إسماعيل سينتكس، وبانتكاسته يسمو اليهود ويأتي المسيح الذي بشر به جل أنبياء إسرائيل.
تغذي هذه النبوءات قناعة اليهود بكونهم شعب الله المختار المبارك الذي سيبني دولته على أنقاض نسل إسماعيل، فيعملون على توظيف جميع الأمم من أجل تحقيق أغراضهم، ويصوبون عداءهم نحو نسل إسماعيل، ويعملون على بث الخراب في دولهم.

وللوعد بتسخير العرب لبناء دولتهم يعتبرونهم عبيدا عندهم، ويستنكفون من الاشتغال في أعمال البناء ويعولون على العمالة الفلسطينية. ولقناعاتهم تلك باتوا يتعسفون على مسار التاريخ ويوجهون الوقائع قسرا لتتطابق مع أساطيرهم ومعتقداتهم ليثبتوا صحة ما جاء في التوراة والتلمود. وأضحوا ينقلبون على كل اتفاق يُعقد خدمة لهذه الأغراض، بدل أن يطوعوا علاقاتهم الدولية لتحقيق المصالح المشتركة حتى يعمّ السلام والرخاء.
ولا تتأتى أهمية هذه النبوءات من مصداقيتها في ذاتها، وإنما من أن سياسيي إسرائيل اليوم باتوا يضبطون أهدافهم الإستراتيجية في ضوئها ويتخذون قراراتهم بناءً عليها. وهذا ما تؤكده وثيقة الاستقلال مثلا، فقد جاء فيها أنّ دولة إسرائيل ستكون مفتوحة الأبواب للهجرة اليهودية وللمّ الشتات، وستدأب على تطوير البلاد لصالح سكانها جميعا، وستكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسلام “مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل “ن ويذكّر بالعهد الذي قطعه الله إلى بني إسرائيل، وفق كتابهم المقدس.

وعليه فما يغفل عنه الفيلم وما يغفل عنه الغرب وهو يقارب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أنّ الشرائع اليهودية تظل الطرف المتحكم في اللعبة السياسية. وأنّ التوراة تمنع معتقديها من إبرام صلح أبدي مع العرب. فنبوءاتها تحتاج إلى استمرار الصراع معهم حتى يقوموا بالدور الذي أوكلته لهم عند اقتراب العصر الميسياني، عصرِ ظهور المسيح وتخليصه للكون من الآثام ونشره للعدل.
فـ”ـلذّته تكون في “مخافة الرب”، وفق تفسير سفر أشعياء، “فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويُميت المنافق بنفخة شفتيه، فتتحد البشرية المؤمنة عندئذ في جسد واحد، وتحمل طبيعة الحب والسلام، فتختفي من حياتها كل ثورة أو عنف أو حب لسفك الدماء والقتل أو التخريب والتدمير.

فَـ”ـيــسْكُنُ الذِّئْبُ مَعَ الْخَرُوفِ، وَيَرْبُضُ النَّمِرُ مَعَ الْجَدْيِ وَالْعِجْلُ وَالشِّبْلُ وَالْمُسَمَّنُ مَعاً وَصَبِيٌّ صَغِيرٌ يَسُوقُهَا. وَالْبَقَرَةُ وَالدُّبَّةُ تَرْعى، وتَرْبُضُ أَوْلاَدُهُمَا مَعاً وَالأَسَدُ كَالْبَقَرِ يَأْكُلُ تِبْناً. وَيَلْعَبُ الرَّضِيعُ عَلَى سَرَبِ الصِّلِّ وَيَمُدُّ الْفَطِيمُ يَدَهُ عَلَى جُحْرِ الأُفْعُوانِ”. وبدون تخريب أرض العرب وتدمير المسجد الأقصى لبناء الهيكل مكانه، لن يأتي هذا المسيح المخلص.
وعامة، مثّل التبسيط سمة الفيلم الأساسية فكان تجسيدا أمينا للفهم الغربي لطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولا نعتقد أنّ هذا العقل الجبار عاجز عن فهم هذا الصّراع بقدر ما نقدّر أنّ خموله شكل من أشكال التهرب من تحمّل المسؤولية. فإسرائيل صنيعة غربية، والشعب الفلسطيني يباد بتخطيط غربي وأسلحته وتمويلاته ومباركته وحمايته في المحافل الدّولية، ورغم جبروته يجبن عند رؤية صورته المشوهة في المرايا.