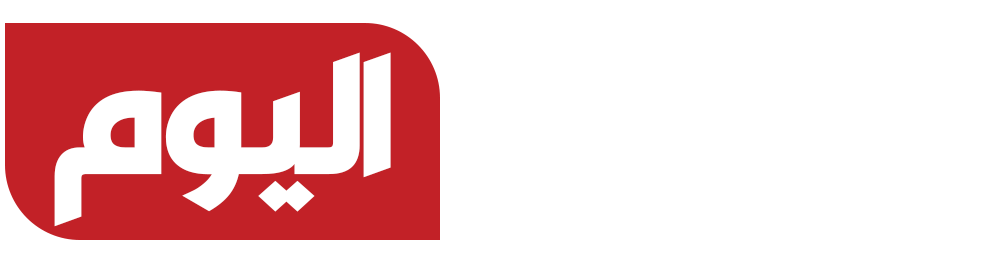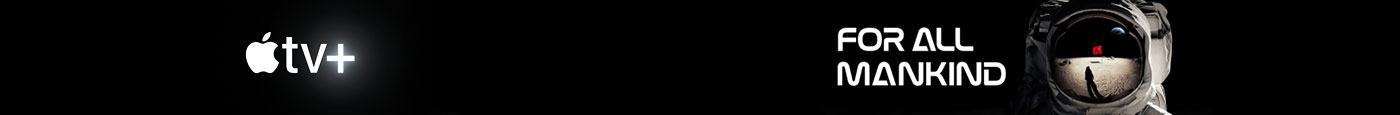باريس – رغم ازدواجية هويته السورية-الفرنسية التي جعلته يعيش على مفترق طرق بين حضارتين وثقافتين ولغتين وذاكرتين وحياتين، فإنه بقي مخلصا لحبه الأول دمشق، وطفولته الأولى بالشام وثقافته الأم “العربية” وكرّس حيواته المختلفة وتجربته الطويلة في خدمتها والتعريف بها في الغرب.
وفي كل المراكز التي عمل بها منذ معهد اللغات الشرقية بباريس، ومرورا بمعهد العالم العربي، ووصولا إلى إشرافه على سلسلة سندباد في دار “أكت سود” (Actes Sud)، كان جسرا ثقافيا حقيقيا بين الشرق والغرب، وكان دوره جوهريا في التعريف بالأدب واللغة والثقافة العربية الإسلامية في فرنسا وأوروبا، من خلال بحوثه وترجماته وإصداراته وكتبه الكثيرة. وقد انطلقت هذه المسؤولية الخطيرة تلقائية شرفية بادئ الأمر، لتتحول بمرور السنين إلى وظيفة حقيقية واعية.
هذا هو الكاتب والناشر والمترجم والمؤرخ السوري الفرنسي فاروق مردم بك الذي ولد في دمشق عام 1944، وتخرج في كلية الحقوق في الجامعة السورية في عام 1965، ويقيم في فرنسا منذ ذلك الوقت.
عمل مردم بك مديرا لمكتبة معهد اللغات الشرقية بباريس، ومحررا في القسم الفرنسي لمجلة الدراسات الفلسطينية (1986-2008)، ومسؤولا عن مكتبة معهد العالم العربي بباريس ثم مستشارا للمعهد، ويشرف منذ سنة 1995 في دار نشر “أكت سود” على سلسلة سندباد التي تختص بترجمة الآداب العربية الكلاسيكية والمعاصرة إلى اللغة الفرنسية.
وتتنوع بحوثه وكتبه بين الأدبي والتاريخي والسياسي، حيث نشر بالفرنسية، بالاشتراك مع سمير قصير، كتابا بعنوان “مسالك بين باريس والقدس، فرنسا والصراع العربي الإسرائيلي”، وبالاشتراك مع إلياس صنبر “أن تكون عربيا” الذي صدر عام 2007 عن دار “أكت سود”. وصدر له عام 2015، في ذكرى الثورة السورية كتابا مهما يحمل عنوان “تاريخ الثورة السورية- أماكن وشخصيات 2011-2015″، يخوض في سيرة شخصيات إبداعية ظهرت إلى النور إبان الثورة.
وبالإضافة إلى كل هذا، ترجم فاروق مردم بك كثيرا من الكتب التراثية والشعرية العربية إلى اللغة الفرنسية، ضمّت مختارات من الشعر الجاهلي والعباسي والأندلسي، على غرار المتنبي والمعري وأبي نواس وأبي العتاهية، كما ترجم إلى الفرنسية أعمالا لمحمود درويش وسعدي يوسف.

وقد حصل مردم بك عام 2018 من الدولة الفرنسية على وسام الشرف من رتبة “فارس” عن مجمل إسهاماته الفكرية والثقافية.
وبمناسبة احتفال سلسلة “سندباد” التي يشرف عليها، في دار “أكت سود” للنشر، بمرور نصف قرن على تأسيسها وإنشائها، كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والناشر فاروق مردم بك الذي تطرق إلى مسيرة هذه الدار العريقة وتخصصها في ترجمة الآداب العربية ونشرها، وخاض في تجربة هذا المثقف الموسوعي بين الكتابة والترجمة والنشر والتأريخ، ورؤيته وتشريحه للثورة السورية وثورات الربيع العربي وهي تحتفل بذكراها الـ12.
-
تحتفل سلسلة “سندباد” التي تشرف عليها بمرور نصف قرن على تأسيسها، فهل حققت هذه المغامرة الأدبية الثقافية أهدافها؟ كيف تقيّم هذه التجربة وكيف عشتها منذ البداية؟
حين أسس بيار برنار دار سندباد في 1972 كان عدد كتب الأدب العربي المترجمة إلى الفرنسية قليلا جدا، وأقل منها ما ترجم إلى اللغات الأوروبية الأخرى. وإذا ما استثنينا كتاب “ألف ليلة وليلة”، كان التراث الشعري والنثري مجهولا خارج دائرة المستشرقين الضيقة. ويرجع أيضا لبيار برنار الفضل في نشر أول رواية بالفرنسية لنجيب محفوظ (زقاق المدق، سنة 1970، قبل تأسيس سندباد)، ثم في العمل حتى سنة 1992 على تعريف القارئ الفرنسي ببعض روائع التراث من الجاحظ وأبي نواس إلى محيي الدين بن عربي، وبكبار الشعراء مثل بدر شاكر السياب وأدونيس، والروائيين مثل الطيب صالح، وصنع الله إبراهيم، وعبد الرحمن منيف.
كان أكثر من نصف إنتاج سندباد يباع في الجزائر، ولذلك عانت الدار من أزمة مالية خانقة حين توقف التصدير في أواخر الثمانينيات، وأصيب بيار برنار بمرض عضال لم يمهله طويلا فتوفي في 1995. انتقلت حينئذ ملكية سندباد إلى “أكت سود” التي كانت على الرغم من حداثة عهدها إحدى أنشط دور النشر الفرنسية في نشر الأدب المترجم، ومنه الأدب العربي المعاصر، وكانت قد تعهدت بالحفاظ على اسم الدار وعلى أهم سلاسلها، وبذلك أصبحت الناشر الأول في أوروبا للأدب العربي المترجم. وجدير بالذكر أن كاتالوغ “أكت سود” كان يشتمل في آخر 2022 على أكثر من 250 ترجمة.
المنافسة بين اللغات شديدة، والمزاج الأدبي في تحول دائم، تتحكم فيه عوامل سياسية واقتصادية وثقافية يصعب التكهن بها.
هل تبوّأ الأدب العربي بهذه الترجمات المكانة التي يستحقها في المشهد الثقافي الفرنسي؟ أجيب: كلا، فالمنافسة بين اللغات شديدة، والمزاج الأدبي في تحول دائم، تتحكم فيه عوامل سياسية واقتصادية وثقافية يصعب التكهن بها.
ولكن باستطاعة القارئ الفرنسي اليوم، بفضل ما ترجم، معرفة الاتجاهات الأدبية العربية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا في حد ذاته إنجاز لا يستهان به. لننظر مثلا إلى ببليوغرافية الشعر الحديث المترجم؛ لا شك في أن الأسماء التي نقع عليها تمثل بجدارة تحولات الشعر العربي الحديث منذ انطلاقته في أواخر الأربعينيات. ولكن لا شك، من جهة ثانية، في أن ما ترجم ليس كل الشعر العربي الذي نتمنى أن يقرأ أيضا في غير لغته الأصلية، ويمكننا تعميم هذا على الرواية والقصة القصيرة.

-
هل تعتقد أن الثورات العربية خلقت أصواتها الإبداعية المستقلة التي ستؤثر في الأجيال القادمة؟ وما خصائص هذه الموجة الإبداعية الثورية ومميزاتها؟ هل ارتقت إلى مستوى اللحظة الثورية؟
قلما أنتجت أعمال أدبية وفنية عظيمة في اللحظة الثورية؛ قد تسبقها وقد تتبعها، ومن النادر جدا أن تعاصرها. أليس هذا ما حدث في فرنسا قبل وبعد السنوات الثورية العشر الفاصلة بين القرنين الـ18 والـ19؟ لا أستهين أبدا بالأدب والفن الثوريين، وكثيرا ما نوهت بهما من حيث تفجر الطاقات الإبداعية على نطاق واسع، في الداخل وفي المنافي والمهاجر، ومن حيث ما تتميز به أعمال الكتاب والفنانين، رجالا ونساء، من تجديد ونضارة وحرية، ولكني واثق من أن حصاد ما بذرته الثورات العربية منذ 2011 لم يحن بعد، وسيكون عظيما حقا.
تظاهر عشرات الملايين من العرب للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هو في حد ذاته ثورة ثقافية، وفشلهم في مسعاهم ليس نهاية التاريخ.
-
هل توافق الرأي القائل إن نجاح الثورة السياسية التي قامت في الدول العربية رهين قيام ثورة ثقافية مبنية على مشروع ثقافي عميق وحقيقي، كما حدث في ثورات إنسانية أخرى كالثورة الفرنسية أو البلشفية أو الماوية؟
كلا، بل أعتبر هذا الكلام، في أحسن الأحوال، هروبا من الانخراط في الثورة، وهو غالبا محاولة فجة لتبرير تغوّل الأنظمة الاستبدادية القائمة، وتماثلها “النظرية” العبقرية القائلة بضرورة تغيير الشعب قبل تغيير النظام، من دون أي اعتبار لأوضاع هذا الشعب التي دفعته إلى التمرد. إن تظاهر عشرات الملايين من العرب للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هو في حد ذاته ثورة ثقافية، وفشلهم في مسعاهم، في 2011 و2019، ليس نهاية التاريخ.
لقد انطلقت الثورات العربية بصورة عفوية لأسباب اجتماعية عميقة، بالإضافة إلى التململ الطويل المكبوت من طغيان الأنظمة الحاكمة، وهذا في زمن لم يعد فيه بإمكانها التحكم بالإعلام ومنع التواصل بين الأفراد والجماعات.
لم تفشل هذه الثورات بسبب غياب مشروع ثقافي عميق وحقيقي، ولكن بسبب قمعها في بعض الأقطار، خصوصا في سوريا، بوحشية تفوق أي وصف.
الأنظمة القائمة على كل حال عاجزة عن حل أي مشكلة من المشاكل التي سبّبت الثورة. ولذلك فهي في أزمة دائمة، تسعى إلى تسويق الفكرة البائسة التي تقول إنه لا خيار إلا بينها وبين التنظيمات الجهادية الظلامية.
تبدو الأنظمة القائمة على كل حال عاجزة عن حل أي مشكلة من المشاكل التي سبّبت الثورة. ولذلك فهي في أزمة دائمة، تسعى إلى تسويق الفكرة البائسة التي تقول إنه لا خيار إلا بينها وبين التنظيمات الجهادية الظلامية، وثمة إعلاميون في خدمتها يدّعون أن هذه التنظيمات -التي ولدت في الحقيقة وترعرعت في رحمها- هي نتاج “الربيع العربي”.

-
برأيك، هل انتهى زمن المثقف العضوي بالمفهوم الغرامشي وأصبحنا نعيش زمن المثقف “العظمي” الذي يرضى بعظمة صغيرة من السلطة في شكل منصب صغير مقابل صمته ومهادنته؟
يجدر بنا ألا نقسو كثيرا على المثقفين العرب، فأكثرهم يعيشون في بلدان لا مهرب لهم فيها من القمع إلا بالتزام الصمت والمهادنة، أو بالهجرة. ولا حاجة إلى إطالة الكلام عن أحوالهم المعيشية التي تضطرهم، في بلادهم وفي المهجر، إلى القبول بشروط المؤسسات التي توفر لهم دخلا ما، وقد يكون سخيا فيتحولون موضوعيا في نهاية المطاف، على اختلاف مواقفهم السياسية وقناعاتهم الفكرية، إلى مثقفين عضويين للأنظمة الراعية لهذه المؤسسات.
أضف إلى ذلك الجوائز التي صارت تضبط بإيقاعها الحياة الثقافية العربية، ولا يكاد يفلت من إغوائها المالي أحد من الكتاب. وأنا أرى، إذ تسألني عن رأيي، أنه من الظلم، في الظروف العربية القاهرة، لوم هؤلاء جميعا أو حتى معاتبتهم ما لم يصبحوا فيما يكتبون ويقولون من “شبّيحة” السلاطين.

لا حصانة في العالم العربي لأي مثقف، خلافا لأمثاله في الدول الديمقراطية حيث لا تقطع أعناقهم ولا أرزاقهم بسبب مواقفهم النقدية.
لا حصانة في العالم العربي لأي مثقف، خلافا لأمثاله في الدول الديمقراطية حيث لا تقطع أعناقهم ولا أرزاقهم بسبب مواقفهم النقدية. أتذكر في هذا السياق ما قاله الجنرال ديغول في 1961 حين استؤذن في اعتقال جان بول سارتر الذي كان أحد الداعين إلى العصيان احتجاجا على الحرب الاستعمارية في الجزائر: “لا يمكن اعتقال فولتير”.
-
عملت محررا في مجلة دراسات فلسطينية كما ترجمت أعمالا لمحمود درويش وسعدي يوسف وغيرهما، فكيف تسترجع صداقتك بمحمود درويش؟ وكيف ترى الفراغ الكبير الذي تركه في خريطة الشعر العربي الحديث؟
نعم، أسعدني الحظ في الثمانينيات، بعد أن استقر محمود درويش في باريس، بالتعرف إليه من كثب، ولعلنا التقينا في تلك السنوات مرتين أو 3 مرات في كل أسبوع. وأسعدني الحظ ثانية في التسعينيات حين أصبحت ناشر ترجمات كتبه والمترجم أو المشارك في ترجمة 3 منها.
إلى جانب أنني كنت في 1981 من مؤسسي مجلة الدراسات الفلسطينية باللغة الفرنسية.
في بيروت ومما نعتز به أن محمود درويش نشر في مجلتنا أول حوار مطول له بالفرنسية عن مسيرته الشعرية، ثم تطورت علاقة كل منا به إلى صداقة شخصية متينة. تحضرني بطبيعة الحال عشرات الذكريات عن حياته اليومية وعاداته وتعليقاته الجادة أو الساخرة على الأحداث الكبيرة والصغيرة. ما يهمني قوله بالدرجة الأولى ردا على سؤالك هو أن الشعر قلما غاب عن ذهنه طوال يومه، وكان يرى كل مجموعة جديدة مرحلة من مراحل بحثه الدؤوب عن ماهية الشعر.
أفتقد محمود درويش صديقا عزيزا كما أفتقده شاعرا كبيرا، ولكني لا أنكر فضل أحد من الشعراء المجيدين الذين سبقوه أو عاصروه، وقد كتب هو نفسه عنهم بمودة وإعجاب، ويبدو لي أنه حاور شعراء قصيدة النثر في شعره الأخير واقترب منهم على الرغم من تمسكه بالتفعيلة واختبار إيقاعاتها. ما يميز محمود درويش حقا عن سواه هو قدرته على الجمع بين الهم الشعري والشعبية الواسعة، وهذه خاصية يصعب أن تتكرر.
-
لماذا بقيت اللغة العربية لغة مهملة في فرنسا رغم أنها “كنز فرنسا المخفي” على حد تعبير جاك لانغ في كتابه الجميل عن لغة الضاد؟ ولماذا لم تأخذ مكانتها التي تستحقها؟
ارتبطت اللغة العربية في فرنسا منذ 3 عقود أو أكثر، على اختلاف مستوياتها وتفرعاتها، بمسائل الهجرة والاندماج والهوية وتلاقح الثقافات أو تنافرها. انقسم أولا المنحدرون من أصل عربي بين الذين يحرصون على تعليم أبنائهم لغتهم، أكان السبب دينيا أو قوميا أو ثقافيا، وبين الذين يعتقدون أن الأفضل تعليمهم لغة أوروبية تفيدهم في حياتهم العملية، خصوصا الإنجليزية.
شاعت فكرة سقيمة سمعنا أصداءها في أثناء الحملتين الانتخابيتين الأخيرتين، الرئاسية والنيابية، مفادها أن اللغة العربية لغة “طائفية”، باعتبارها لغة القرآن، ودعا اليمين المتطرف علنا إلى إهمالها، بل محاربتها.
وإضافة إلى ذلك، شاعت فكرة سقيمة، سمعنا أصداءها في أثناء الحملتين الانتخابيتين الأخيرتين، الرئاسية والنيابية، مفادها أن اللغة العربية لغة “طائفية”، باعتبارها لغة القرآن، ودعا اليمين المتطرف علنا إلى إهمالها، بل محاربتها، وهي أصلا في موقع متدنّ في المدارس الإعدادية والثانوية، إذ تأتي في المرتبة السابعة من اللغات التي تدرس فيها، في حين أنها اللغة المحكية الثانية في البلاد.

مع ذلك، أعتقد أن من الخطر حصر تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية بالمنحدرين من أصل عربي أو إسلامي. المهم تدريسها على نطاق أوسع، على أنها لغة ثقافة حية وتراث إنساني رفيع.
-
كيف تعيش هذه الازدواجية في الهوية باعتبارك سوريًّا-فرنسيًّا، هل هي مصدر ثراء وغناء وتحرر وإنسانية لك أم مصدر شقاء وتقوقع وتذبذب بين لغتين وثقافتين وحضارتين وحياتين؟
أقيم في فرنسا منذ 1965، وأعمل فيها منذ 1972، وحصلت على الجنسية الفرنسية سنة 1983. كنت قبل مغادرتي دمشق أجيد اللغتين العربية والفرنسية، كلاما وقراءة وكتابة، وشاء القدر أن تتيح لي جميع المهن التي مارستها بعد وصولي إلى باريس أن أعبر الحدود يوميا، ذهابا وإيابا، بين الثقافتين واللغتين، ولذلك لا أشعر بأي غربة عن المجتمع الفرنسي، وقد “تفرنست” بطبيعة الحال في حياتي اليومية، مثل أعداد غفيرة من المهاجرين العرب. يدعوني هذا كله إلى اتخاذ مواقف جذرية في السياسية الداخلية والخارجية، شأني شأن الفرنسيين الديمقراطيين المعادين للرأسمالية المتوحشة والعنصرية بجميع أشكالها، المنحازين لتراث بلادهم الثوري، المنددين بتاريخها الاستعماري.
-
قام المفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد في كتابه “الاستشراق” بتعرية المركزية الغربية ونقد الأسس الواهية التي قامت عليها وقام عليها الاستشراق بوصفه تيارا معرفيا جاء في سياق تاريخي كولونيالي، فلماذا تواصلت هذه النظرة الاستشراقية الغربية إلى الحضارة العربية الإسلامية، رغم تجاوزنا لهذا السياق التاريخي؟ وما أسبابها العميقة؟
هل تواصلت هذه النظرة الاستشراقية فعلا؟ ثمة شطط في استخدام هذا المصطلح، أعني الاستشراق، في العالم العربي، فهو يشمل الغث والسمين: من الأيديولوجية الاستعلائية العنصرية في سياقها الكولونيالي، وهي مستمرة بأشكال مختلفة وينبغي التنديد بها، إلى الدراسات الغربية الرصينة عن الإسلام وتاريخه الاجتماعي والثقافي.
أعتقد أن نقد الاستشراق عند إدوارد سعيد ينصبّ على هذه الأيديولوجية في أعمال المستشرقين لا على إسهاماتهم المعرفية، ولا يعني تسفيه الدراسات الغربية جملة وتفصيلا إذا كانت لا تتوافق مع نظرة العرب والمسلمين إلى أنفسهم.