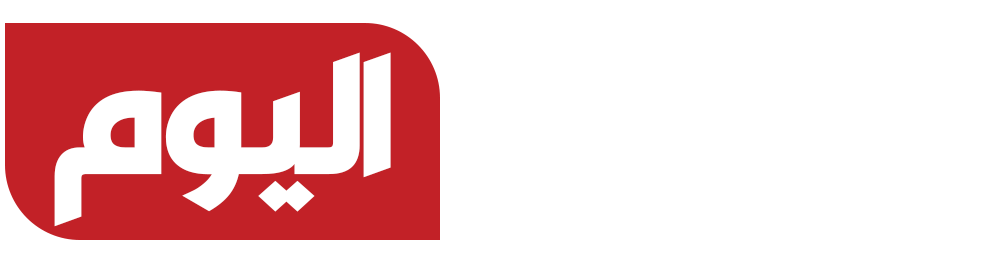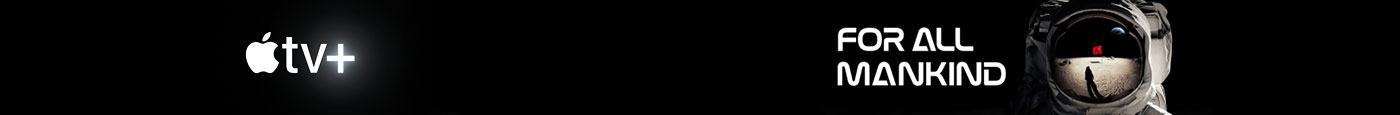الخرطوم- تكتب الحروب تواريخ جديدة، وتصنع حقبا ثقافية، بل ومدنا جديدة في بعض الأحيان.
وفي السودان، غيرت الحروب العواصم، فانتقلت إلى الخرطوم كما انتقلت منها أيضًا في تغيرات تاريخية وفكرية.
سنار والسنانير
شهد عام 1504 قيام سلطنة الفونج التي عرفت بـ”السلطنة الزرقاء” والتي اتخذت من سنار (نحو 300 كلم جنوب الخرطوم) عاصمة لها.
لم تكن السلطنة تضم كل حدود السودان الحالي، لكنها كانت كبيرة ممتدة، وكانت سنار حاضرة بها حركة تجارية وعلمية وتأتيها مختلف الجنسيات، حسب ما ذكر المؤرخون، وكانت نابضة بالحياة حسب الأكاديمي والباحث خالد محمد فرح.
ويقول فرح -في حديثه مع “الجزيرة نت”- عمَّا دونه الرحالة عن سنار، ومنهم القس البافاري ثيودور كرُمب الذي زارها نحو عام 1700، إنه وصفها بثاني أكبر مدينة في أفريقيا قاطبة بعد القاهرة، وبكونها مدينة عالمية بها أناس من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان، وأنهم يعيشون جميعا في سلام وتناغم.
وبلغ من عظم سلطنة سنار أن كتبت القصائد تمدح سلاطينها، كما جاءت قصيدة الشاعر عمر المغربي أحد المشايخ الأزهريين والتي جاء فيها:
أيا راكبا يسري على متن ضامر إلى صاحب العلياء والجود والبر
لك الخير إن وافيت سنار قف بها وقوف محب وانتهز فرصة العمر
وإلى سنار انتسب كل من كانت منطقته تحت حكم “السلطنة الزرقاء”، لذلك تجد رواق السنارية في الأزهر، وتجد المادح حاج الماحي (1789-1871) يقول في وصفه رحلتهم للحج:
نوصل مدينة الخير النائب والمدير
قالوا لنا بي تبشير حباب “السنانير”
وصارت سنار من بعد ذلك رمزا للتعايش والانصهار العرقي بين القبائل العربية وغيرها، وجعلها الشاعر محمد عبد الحي (1944-1989) نموذجًا يتمنى العودة إليها ورسخ ذلك في مطولة باسم “العودة إلى سنار”، لكن في يونيو/حزيران 1821 سقطت سلطنة سنار في يد جيش والي مصر آنذاك محمد علي باشا الذي ضمها لحكمه.
من سنار إلى الخرطوم
بعد أن دان الأمر للجيش الغازي، انتقل الباشا بجنوده شمالا لمدينة ود مدني (190 كلم جنوب الخرطوم)، قبل أن تُنقل العاصمة إلى الخرطوم في عهد الحكمدار محو بك أورفلي لتبدأ حقبة تاريخية جديدة.
ويورد المؤرخ المصري عبد الله حسين، في كتابه “السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية”، حديثًا عن إنشاء المدن في عهد محمد علي “من ذلك إنشاء مدينة الخرطوم التي كان موقعها محلة صغيرة للصيادين، وجُعلت سنة 1822 معسكرًا للجيش”.
ثم يصف الكتاب ملامح التأسيس، قائلا “أسست بها سراي الحكومة بالطوب الأحمر من دورين، وسراي مديرية الخرطوم، ومسجدان، ودار لبعثة دينية مسيحية، وثكنة للجنود شرقي المدينة، ومستشفى، ومصنع للبارود، ومخزن للمؤن، وترسانة بها مسبك للحديد، ومصنع للنجارة”.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الخرطوم كانت موجودة قبل ذلك بقرون؛ ويفيد الدكتور خالد محمد فرح بأنها كانت قرية خاملة الذكر إلى أن حلَّ بها الشيخ أرباب بن علي الشهير بـ”أرباب العقائد” (1612-1691) عابرًا النيل الأزرق من جزيرة “توتي”، فأقام فيها مسجده وخلوةً (كُتّابًا) لتعليم القران ونهضت المدينة من حول ذلك المعلم الثقافي والتعليمي والديني.
ولما كان ارتباط العواصم واضحًا في بعض الأحيان بالتغير الثقافي، سألنا أستاذ التاريخ الحديث محمد الفاضل إن كان لنقل العاصمة علاقة بذلك، فقال: “لا شك أن نقل العاصمة يساعد في تكوين حقبة ثقافية جديدة”، لكن ذلك لم يكن سببًا لنقل العاصمة، حسب إفادة الفاضل للجزيرة نت، بل البعد الجغرافي عن القاهرة والحاجة لعاصمة يكون التواصل بينها ومصر أيسر.
بين مدينتين
أتى الحكم الجديد بمفاهيم جديدة وبتنظيم مختلف وجعل العاصمة الحديثة أكثر ارتباطا بالعالم، فعمّرها تجار من جنسيات مختلفة، كما أن الحكام الجدد استعانوا بموظفين مصريين وشوام وأرمن وبعض الأوروبيين وقام بعض الحكام بجذب السودانيين وصارت الخرطوم مدينة عامرة.
وفي كتاب “عصر محمد علي” للمؤرخ المصري عبدالرحمن الرافعي، يذكر “أن عدد سكان الخرطوم قد بلغ 30 ألفًا في عهد محمد علي، وزاد العدد إلى 40 ألفًا سنة 1854، و50 ألفًا سنة 1856″، وهي بذلك مدينة متعددة الأعراق والمهن والثقافات، يعيش فيها الناس بنمط مغاير لما اعتاد عليه أهل البلاد.
وفي ذلك، يقول فرح إن “الخرطوم صارت عاصمة للبلاد، ومن ثم جعلت الجاليات الأجنبية تفضل سكناها، مما أعطاها مسحة إفرنجية بصفة عامة”، هذه المسحة الإفرنجية مع الاستعانة بحكام من غير المسلمين جعلت الخرطوم مكانا مختلفًا، ومكانا فاسدًا عند ثوار الثورة المهدية التي وصلت ذروتها عام 1885 وسقوط المدن تباعا على يد الإمام محمد أحمد المهدي، لذلك يقول شاعر المهدية محمد عمر البنا (1848-1919):
فانهض إلى الخرطوم إن بسوحه أهل الغواية والمفاسد باتوا
وهي في الفكر المهدي “مدينة التُرك” التي على رأسها رجل غير مسلم (الجنرال غردون)، وعلى الغرب منها نزل المهدي في ديم أبو سعد الذي يفصله النيل الأبيض عن الخرطوم، ثم جعل له معسكرًا في موقع شماله (أم درمان)، وابتنى مسجده ومنزله وعسكر بها جيشه ومنحها اسم “البقعة المباركة”، وكان النظرة لأم درمان فيها شيء من القداسة كونها المكان الذي نزل فيه المجاهدون، ومن هناك فتحوا الخرطوم في يناير/كانون الثاني 1886.
فتح الخرطوم
مثلما جعلت الحرب الخرطوم عاصمة، نزعت الحرب ما أعطت ولم تعد الخرطوم عاصمة للبلاد، وصار النيل الأبيض الفاصل بين الخرطوم وأم درمان، فاصلا بين حقبتين مختلفتين فكرًا وثقافة.
يذكر البروفيسور والمؤرخ روبرت كرامر في كتابه “أم درمان: مدينة مقدسة على النيل، ترجمة بدر الدين الهاشمي”، بناءً على منشورات المهدي أنه لم يكن راغبا في بناء مدينة أو عاصمة جديدة، فقد كان هدفه القيام “بإصلاح إسلامي شامل”.
وعن الشهور التي تلت فتح الخرطوم، يقول كرامر إن “المهدي بقي في البداية في ديم أبي سعد، بينما سكن أقرباؤه وأنصاره في بيوت العاصمة السابقة، ولحق المهدي لاحقا بجنوده في المعسكر المزدهر الذي هو أم درمان، وبقي هنالك حتى وافته المنية”.
ويذكر كرامر أن المهدي استنكر السكنى في الخرطوم، لكن المنية كانت أعجل إذ توفي بعد 6 أشهر من فتح الخرطوم.
وبعد شهر واحد من وفاة المهدي، أمر الخليفة عبد الله التعايشي (خليفة محمد أحمد المهدي زعيم الثورة المهدية) في منشور له كل سكان الخرطوم بإخلائها والانتقال لأم درمان للسكن بها، ثم كان أن أمر الخليفة زعماء القبائل والتجار بالقدوم للعاصمة، أما الخرطوم فقد تغير حالها، حسب وصف كرامر الذي كتب “أصبحت الخرطوم مكانا تؤخذ منه بقايا الأخشاب والطوب ومواد البناء الأخرى، ومع مرور الأيام غدت مدينة شبه محطمة”.
في المقابل، نمت أم درمان وازدهرت وكان للتهجير الكبير إليها أثر في تشكل بنية سكانية جديدة رغم أن البعض هجّر قسوة.
حياة جديدة
بعد 13 سنة من حكم المهدية، وقع السودان تحت الحكم الإنجليزي المصري، وأعاد الإنجليز الحياة للخرطوم المحطمة فجعلوها عاصمة مرة أخرى، وبدؤوا في إعمارها بتخطيط جديد.
أما أم درمان، فقد قل عدد سكانها نتيجة للمعارك ولتقهقر بعضهم مع الخليفة عبد الله التعايشي قبل أن تدور المعركة الأخيرة خارجها، كما أن بعضا ممن أرغموا على المكث فيها أيام الخليفة عادوا إلى ديارهم الأصلية.
وفي إفادته المتصلة للجزيرة نت، يقول الفاضل “ظلت الحالة العقائدية من كون أم درمان البقعة المباركة لسنوات. واستمر هذا البعد حتى عند غير المتوافقين مع فكر المهدية”، فصارت الخرطوم مدينة للإنجليز والموظفين من المصريين والشوام واليونانيين وغيرهم من الأجانب، ولم تزل في مخيال كثير من السودانيين بذات الصورة القديمة (مدينة التُرك) ويعبّر عن ذلك الشاعر السوداني الكبير محمد المهدي المجذوب (1919-1982)، قائلا:
آه من قريتي البريئة لا تعلم كم في مدينة الترك أشقى
أما أم درمان فكانت شعبية الطابع في كل مبانيها وأسواقها وكل مظاهر الحياة، التي تشكلت فيها تركيبة سكانية جديدة ضمت أغلب قبائل السودان، إن لم تكن كلها، ووحدت تلك التركيبة المكونات المختلفة وأنتجت ثقافة أم درمانية جديدة، تغنى بذكرها الشعراء.
وارتبطت أم درمان بالمقاومة والوطنية وكانت مسكنا لأغلب القيادات الوطنية، وبها قام نادي الخريجين الذي لعب دورا كبيرا في الحركة السياسية السودانية والجمعيات الأدبية ذات النشاط السياسي الخفي.
جنة رضوان
رغم الرمزية التاريخية لأم درمان، فإن جيل الاستقلال رأى الاستفادة من البنايات الحكومية التي تتمتع بها الخرطوم، صاحب ذلك نمو المدينتين (الخرطوم، وأم درمان) وشقيقتهما الثالثة (الخرطوم بحري) حتى كأنهم مدينة واحدة، خاصة مع الجسور التي ربطت بينها فصارت العاصمة المثلثة، ولم تعد هناك فروق ثقافية بالمعنى الواضح.
وحتى تلك الفروق التي ظلت قائمة شكلت مميزات وخصوصية لكل مدينة، فكتب الشعراء في تاريخ أم درمان وفي جمال الخرطوم الذي استرعى حتى غير السودانيين، فكتب الشاعر المصري صلاح عبد الصبور “أيا سمرا” ووصفها إبراهيم رجب بـ”جنة رضوان”:
يا الخرطوم يا العندى جمالك.. جنة رضوان
طول عمرى ما شفت مثالك
في أي مكان
وأوفت خرطوم ما بعد الاستقلال بكل أدوارها الوطنية، وتجاوزتها للعب أدوار إقليمية، ويتمنى السودانيون أن تنطفئ نار الاشتباكات التي شبت في عاصمتهم، وتعود “جنة رضوان” بكل ما فيها من خير وجمال.