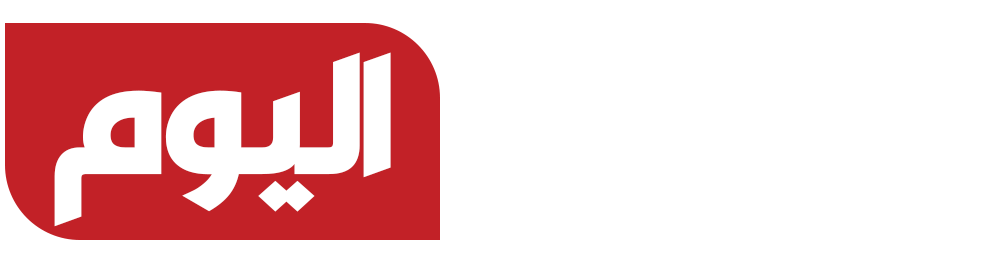كشف أطباء نفسيون أن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية لاتزال تدفع بعض المرضى إلى زيارة العيادات سراً، في حين يرفض آخرون العلاج رغم حاجتهم إليه؛ خوفاً من نظرة المجتمع لهم، مؤكدين أن الخجل من زيارة الطبيب النفسي ليس مسألة فردية، بل ظاهرة مجتمعية متجذرة، تعود إلى أفكار قديمة تعد زائر الطبيب النفسي «مجنوناً» أو ضعيف الشخصية، ويتأثر فيها المرضى بالقيم والتوقعات التي ترسّخت لديهم منذ الصغر، حيث يخشى كثيرون ما قد يرمز إليه المرض النفسي اجتماعياً أكثر من خوفهم من المرض ذاته.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الخوف يجعل بعض المرضى يفضّلون الاستمرار في الألم على مواجهة الحكم الاجتماعي، إذ إن هناك حالات لمرضى عاشوا سنوات طويلة مع أعراض نفسية شديدة، ليس لغياب الألم، بل لأنهم اعتبروا المعاناة جزءاً من هويتهم أو شخصياتهم، مردّدين – بشكل غير مباشر – «هكذا أنا» أو «هذا ابتلاء يجب تحمّله»، ومن أكثرها إيلاماً حالات لمرضى يعانون اضطراب الوسواس القهري بدرجات شديدة، عاشوا وفق قواعد صارمة ومنهِكة دون إدراك أن ما يعيشونه قابل للفهم والعلاج.
وأوضحوا أن هناك أربعة أسباب رئيسة تشكل عوائق وحواجز أمام طلب العلاج لهؤلاء المرضى، وتشمل: «الخوف على الوظيفة أو المسار الدراسي، والقلق من سرية المعلومات وخصوصية الملفات الطبية، ونقص أعداد الاختصاصيين النفسيين وطول قوائم الانتظار، ومحدودية التغطية التأمينية الصحية التي تواجه المرضى في العلاج والجلسات».
الصمت وتأجيل العلاج
وتفصيلاً، قال استشاري الطب النفسي، الدكتور رياض خضير، إن الصحة النفسية لاتزال – للأسف – مرتبطة بالوصمة في مجتمعنا، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى أفكار قديمة تعد زيارة الطبيب النفسي «جنوناً» أو ضعف إيمان أو ضعف شخصية، إلى جانب قلة الوعي الصحي، والخوف من كلام الناس، وعدم الحديث المفتوح عن الصحة النفسية في السابق، وهي عوامل جعلت هذه النظرة تستمر حتى اليوم.
وأوضح أن بعض الأشخاص يشعرون بالخجل من الاعتراف لأنفسهم بالحاجة إلى الدعم النفسي، لأن كثيرين تربّوا على فكرة أن الإنسان القوي لا يشتكي ولا يطلب مساعدة، فيبدأ الشخص بإنكار تعبه، ويشعر بالذنب أو الضعف إذا اعترف بحاجته للعلاج، رغم أن المرض النفسي مثل أي مرض جسدي يحتاج علاجاً.
وأضاف أن الخوف من حكم الآخرين أو نظرة العائلة يلعب دوراً كبيراً في إنكار المشكلة، حيث يخاف البعض من الوصمة أو الانتقاد أو المعاملة بشكل مختلف، فيفضّلون الصمت وتأجيل العلاج، رغم أن هذا التأجيل قد يزيد الحالة سوءاً.
وأكد أن هناك حالات كثيرة ترفض العلاج فقط؛ خوفاً مما يعدونه وصمة نفسية، موضحاً أن بعض المرضى يعلمون أنهم بحاجة للمساعدة، لكنهم يرفضون العلاج؛ خوفاً من أن يعرف أحد، فيؤثر ذلك في سمعتهم أو عملهم أو زواجهم.
وأشار إلى أن هناك أشخاصاً يعانون – لسنوات – قلقاً أو اكتئاباً، لكنهم يزورون الطبيب سراً بعد تعب شديد، أو يراجعون بعد ظهور أعراض جسدية قوية، في حين يكون السبب نفسياً، نتيجة الخوف من طلب المساعدة مبكراً.
ولفت إلى أن نظرة الأهل تختلف غالباً بين جيل الآباء والأبناء، حيث يكون الجيل الأكبر أكثر تحفظاً، في حين أن الشباب أكثر وعياً وتقبّلاً، مؤكداً أن هذا الاختلاف قد يضع المريض تحت ضغط، خصوصاً إذا لم يجد دعماً من أسرته، ما يؤخر العلاج أو يضعف نتائجه.
وشدّد على أن الصحة النفسية جزء من الصحة العامة، ولا عيب في طلب المساعدة، داعياً إلى زيادة التوعية، والحديث عن الصحة النفسية بشكل طبيعي، ودعم العائلة للمريض بدل لومه، مؤكداً أن زيارة الطبيب النفسي خطوة شجاعة وليست ضعفاً.
خلل في الشخصية
وأكدت الاختصاصية النفسية الدكتورة رنا أبونكد، أن الصحة النفسية لاتزال مرتبطة بالوصمة في مجتمعنا، وإن كانت أقل حدّة مما كانت عليه في السابق، موضحةً أن هذه الوصمة، لا تنبع من القسوة بقدر ما تنبع من الخوف وسوء الفهم، قائلة: «كثير من الناس يخشون ما لا يفهمونه، ويخشون أن يُساء تفسير معاناتهم النفسية على أنها ضعف أو خلل في الشخصية، لا تجربة إنسانية قابلة للفهم والعلاج».
وأشارت إلى أن هذه النظرة تتجذر في موروثات ثقافية طويلة اعتادت على تمجيد الصبر والصمت، وربط القوة بالكتمان، إضافة إلى خلط الصحة النفسية بالجوانب الدينية أو الأخلاقية، بدل النظر إليها كونها جزءاً أصيلاً من الصحة العامة.
وحول الخجل الداخلي من طلب المساعدة، أوضحت أن الوصمة غالباً ما تكون داخلية قبل أن تكون اجتماعية، حيث ينشأ الفرد وهو يتعلّم بشكل مباشر أو غير مباشر أن المعاناة النفسية تعني الضعف أو الفشل أو فقدان السيطرة، فيتبنى هذه الرسائل ويوجهها إلى ذاته، مضيفة أن الاعتراف بالحاجة إلى دعم نفسي يتطلب مواجهة الألم بدل الاستمرار في إنكاره، وهو أمر مخيف لكثيرين، إذ يصبح الإنكار آلية دفاع مؤقتة تحمي الشخص من الشعور بالعجز أو من تغيير صورة الذات، إلى جانب قلة الوعي أو غياب الإلمام بالصحة النفسية وأمراضها.
وأكدت أن الخوف من حكم الآخرين ونظرة الأسرة يلعب دوراً كبيراً في إنكار المشكلة أو تأجيل العلاج، مشيرةً إلى أن كثيرين لا يخشون المرض النفسي بحد ذاته، بقدر ما يخشون ما قد يرمز إليه في نظر محيطهم، مثل الخوف من أن يُوصَفوا بالضعف، أو أن يُختزلوا في تشخيص، أو أن يُنظر إليهم كونهم عبئاً على عائلاتهم.
وأضافت أن رفض العلاج خوفاً من الوصم الاجتماعي أمر شائع في الممارسة الإكلينيكية، حيث لا يرفض بعض المرضى العلاج لعدم حاجتهم إليه، بل بسبب الخوف من «الكلام»: ماذا سيقول الناس؟ من سيعرف؟ وكيف ستتغير نظرتهم؟ وأحياناً يكون الخوف من الوصمة أقوى من المعاناة نفسها، فيُفضّل الفرد الاستمرار في الألم على مواجهة الحكم الاجتماعي المحتمل.
وتطرقت إلى نماذج إنسانية مؤثرة، موضحةً أنها صادفت حالات عاش فيها المرضى لسنوات طويلة مع أعراض شديدة، ليس لغياب الألم، بل لأنهم اعتبروا المعاناة جزءاً من هويتهم أو شخصياتهم. وقالت: «كان بعضهم يقول بشكل غير مباشر: هكذا أنا، أو هذا ابتلاء ويجب أن أتحمّله»، لافتة إلى أن أكثر الحالات إيلاماً، كانت لأشخاص يعانون اضطراب الوسواس القهري بدرجات شديدة، عاشوا سنوات وفق قواعد صارمة ومُنهِكة تنظّم تفاصيل حياتهم اليومية، دون إدراك أن ما يعيشونه أعراض قابلة للفهم والعلاج.
وفيما يتعلق باختلاف نظرة الأسرة، أوضحت أن الجيل الأصغر يتمتع عموماً بوعي أكبر بالصحة النفسية، إلا أن بعض أفراد الجيل الأكبر شهدوا أيضاً ارتفاعاً واضحاً في مستوى وعيهم النفسي مع مرور الوقت، مؤكدةً أن التغير لم يعد حكراً على جيل معين، بل هو نتاج تراكم الخبرات، والانفتاح الإعلامي، وتجارب شخصية أو عائلية قرّبت مفهوم العلاج النفسي إليهم.
وأكدت أن الخجل والوصمة الاجتماعية ليسا مسألة فردية فقط، بل ظاهرة مجتمعية متجذرة، حيث يتأثر المرضى بالقيم والتوقعات التي تعلموها منذ الصغر، مشددةً على أن معالجة هذه المشكلة تتطلب التعامل مع الفرد والأسرة والمجتمع في آنٍ واحد.
وحول المخاوف المهنية والدراسية، قالت إن الخوف على الوظيفة أو المسار الدراسي شائع جداً بين المرضى، وأكثر المخاوف تتعلق بسرية المعلومات وخصوصية الملفات الطبية، إذ يقلق البعض من تسرب بياناتهم أو النظر إليهم بشكل سلبي في بيئة العمل أو الدراسة، موضحة أن هذه المخاوف غالباً مبنية على تصورات خاطئة، لا على الواقع القانوني أو المهني الفعلي.
وأضافت أن سياسات المؤسسات تلعب دوراً محورياً في شعور الأفراد بالأمان، فوجود سياسات واضحة تدعم الصحة النفسية وتؤكد السرية وعدم التمييز يمنح الثقة لطلب المساعدة، في حين يؤدي غيابها أو غموضها إلى القلق والتأجيل والإنكار، مشيرة إلى أن بعض الجهات تمتلك برامج لدعم الموظفين، إلا أن غياب الوضوح والضمانات المتعلقة بالسرية يدفع البعض للجوء إلى دعم خارجي بدل الاستفادة من البرامج الداخلية.
وأوضحت أن العوائق أمام العلاج النفسي ليست نفسية فقط، بل خدمية وتنظيمية أيضاً، ومن أبرزها نقص عدد الاختصاصيين والأطباء النفسيين مقارنة بعدد المحتاجين للعلاج، ما يؤدي إلى قوائم انتظار طويلة، إضافة إلى التغطية التأمينية المحدودة أو غير الشاملة للعلاج النفسي، حيث تغطي بعض التأمينات الأدوية فقط دون الجلسات العلاجية.
مفاهيم مغلوطة
وأكدت الاختصاصية النفسية، حصة الرئيس، أهمية الحاجة إلى مزيد من التثقيف النفسي والحوار المجتمعي لتصحيح المفاهيم المتبقية، وترسيخ فكرة أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يختلف عن الاهتمام بالصحة الجسدية، وأن طلب المساعدة قوة ووعي وليس ضعفاً.
وأوضحت أن أكثر الأفكار المغلوطة والمفاهيم الشائعة التي لاتزال تواجهها هي أن زيارة الطبيب أو المعالج النفسي تعني أن الشخص «مجنون» أو «غير واعٍ» أو «ناقص أهلية» أو «ضعيف الشخصية»، مؤكدة أن هذه تصنيفات غير صحيحة ولا تمتّ للواقع العلاجي بصلة.
وقالت إن العلاج النفسي يشمل التعامل مع الاكتئاب، والقلق، والضغوط النفسية، والصدمات، واضطرابات النوم، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي وتطوير المهارات النفسية وتحسين جودة الحياة، لافتةً إلى أن كثيراً من المراجعين أشخاص أسوياء وناجحون، لكنهم يمرون بمرحلة تحتاج إلى دعم متخصص.
وأضافت أن تأثير هذه المفاهيم الخاطئة يظهر بوضوح في قرار طلب العلاج، حيث تدفع الناس إلى التردد والخجل وتأجيل المراجعة خوفاً من نظرة المجتمع أو الوصمة، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى تفاقم المعاناة بدل علاجها في وقت مبكر.
وبيّنت أن الخلط بين المرض النفسي والضعف الشخصي أو قلة الإيمان يسهم بشكل كبير في تأخير العلاج أو رفضه، إذ يشعر الشخص بالذنب والخجل بدل الشعور بحقه في طلب المساعدة، وقد يلجأ إلى إنكار معاناته أو تحمّل الألم بصمت، مؤكدة أن الإيمان والقوة النفسية لا يتعارضان مع العلاج، بل يمكن أن يتكاملا معه، مشددةً على أن المرض النفسي له أسباب بيولوجية ونفسية واجتماعية، ولا يعني ضعف الإرادة أو التقصير الديني.
وبينت أن لغة الناس اليومية عند ذكر مصطلح «طبيب نفسي» تكشف بوضوح عن عمق الوصمة أو الخجل المرتبط به، فكثيراً ما يُقال المصطلح بنبرة خفض الصوت، أو على سبيل المزاح والسخرية، أو يُستبدل بعبارات ملتفة مثل «بس يفضفض» أو «يرتاح عند مختص» دون تسمية واضحة، وكأن ذكر الاسم الصريح أمر محرج، كما تظهر الوصمة في استخدام المصطلح كـأداة تهكم أو اتهام، مثل قول «روح لطبيب نفسي» عند الغضب أو الخلاف، ما يعزز الربط السلبي بين العلاج النفسي والخلل أو الجنون، مؤكدة أن هذا الاستخدام اللغوي اليومي، حتى لو كان دون قصد، يرسخ صورة مشوهة عن العلاج النفسي في الوعي الجمعي.
وأكدت أن الخجل من زيارة الطبيب النفسي قضية مجتمعية وليست فردية، داعيةً إلى تعزيز التثقيف النفسي منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطبيع الحديث عن المشاعر والصحة النفسية، وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم محتوى نفسي صحيح وبعيد عن السخرية، وتشجيع النماذج الإيجابية التي تتحدث عن تجاربها العلاجية بوعي، وتصحيح المفاهيم الدينية والاجتماعية الخاطئة.
ودعت إلى أهمية إدراج الصحة النفسية في المناهج الدراسية، وتكثيف حضورها داخل المؤسسات من خلال توفير مرشدين أو اختصاصيين نفسيين، مؤكدةً أن زيارة الطبيب النفسي حق وليست عيباً، وأن العناية بالصحة النفسية خطوة أساسية للعيش بتوازن وسلام نفسي، تماماً كالعناية بالصحة الجسدية.
. 4 أسباب رئيسة تشكل عوائق أمام طلب العلاج.. أبرزها القلق من سرية المعلومات وخصوصية الملفات الطبية، ومحدودية التغطية التأمينية الصحية.