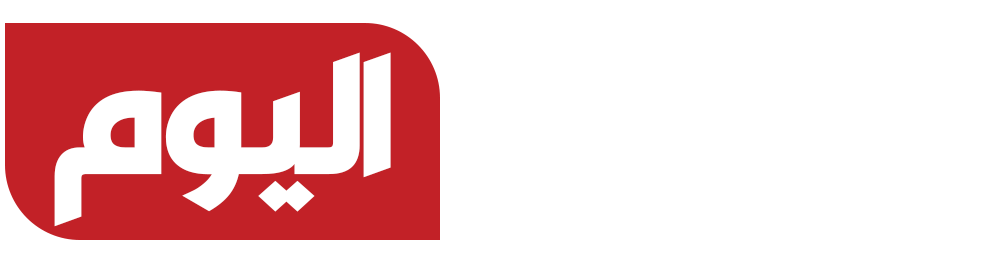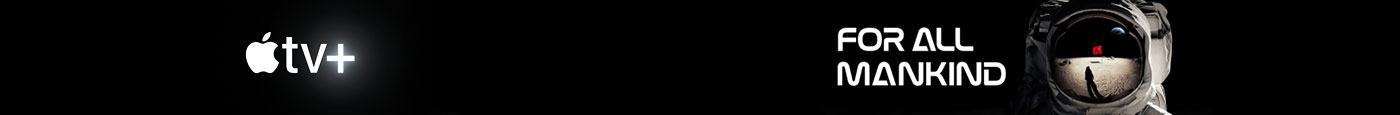درنة- قبل عام، تبدّلتْ ملامح مدينة درنة التي حوّلها الطوفان من حاضرة زاهرةٍ إلى أخرى منكوبة، مُبتلعًا ثُلثها ملقيًا به -غير مبالٍ بما حمله من بشرٍ وحجر في عرض البحر، في كارثة اعتبرت الأسوأ في تاريخ ليبيا الحديث، تسببت في تشريد ما يزيد على 45 ألف شخص منهم أكثر من 16 ألف طفل.
مرّ هذا الوقت الطويل على الفاجعة دون الكشف عن عدد الضحايا -الحقيقي- حتى اللحظة، ليطرح السؤال: ماذا تغير في درنة على مدار 12 شهرًا؟
ولماذا تتمسك السلطات الليبية بعدم الإفصاح عن العدد الحقيقي لضحايا درنة؟ وما نسبة الإنجاز في مشاريع الإعمار؟ وما التحديات النفسية للناجين؟ وكيف أثرت الكارثة على المشهد الاقتصادي والاجتماعي والأدبي بالمدينة؟
جديد الإعمار
وفي سياق مستجدات مشاريع الإعمار، أكد صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا أن الحياة بدأت تعود تدريجيًا في درنة، إذ تجاوزت نسبة إنجاز المشاريع والإعمار بعد عامٍ من الكارثة 50% بعدد 295 مشروعًا في كامل المدينة.
وعلى مدارعام، انتهجَ صندوق التنمة 3 مراحل لإعادة إعمار درنة:
- العمل على فتح المسارات والشوارع وإزالة الطمي.
- البدء في الإعمار والتشييد مع شركات دولية.
- تعويض الأهالي المتضررين ببيوت جديدة مجهزة بالكامل.
وقد تم استكمال بناء ألفي وحدة سكنية بعد توقف منذ عام 2009، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 40%. وبعد الكارثة استأنفت أعمال البناء ووصلت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 80%.
توصيـات اقتصادية
وبخصوص جانب الخسائر الاقتصادية وآفاق التعافي، اقترح الخبير الاقتصادي علي الصلح مرحلتين قصيرتي الأجل للنهوضِ باقتصاد درنة:
- تفعيل الميناء والمصارف بشكل مختلف عبر استهداف المشاريع الشمولية.
- عودة الحياة الثقافية والاجتماعية واستهداف مشاريع من شأنها إيجاد بيئة سياحية، إلى حين استكمال مشاريع إعادة الإعمار.
واعتبر الصلح أنَ الخسائر البشرية تنعكسُ بشكلٍ سلبي على النمو الاقتصادي، لأن الخسائر البشرية تحتاج إلى الكثير من الوقت لإعادة دورتها الاقتصادية ودخولها للسوق من جديد على كافة الصُعد.
في حين قدر الخبير والباحث الاقتصادي علي دريميش زمن تعافي درنة من 3-4 سنوات، معتبرًا أنَ الخسائر كبيرة لا تقدر بثمن وأبرزها الخسائر البشرية بما فيها من كفاءات بمختلف التخصصات بالإضافة إلى الخسائر في الأصول الثابتة كالعقارات والمباني والبنية التحتية.
محاولة تأريخ
“لا موتَ في حياةٍ رابضة” هكذا تردُ محبوبة خليفة وهي شاعرة ومؤلفة من درنة، حول سؤال الجزيرة نت عن كيفية نهوض الحركة الأدبية في المدنية من جديد بعد الفاجعة. فتقول إن درنة فقدت الكثير من الأدباء والشعراء ممن سيتركون فراغًا في ذاكرة المدينة الأدبية.
وحذرت محبوبة من تبعاتِ وصفتها بالكبيرة نتيجة هذه الخسارة إذ فُجِعَت المدينة بالفعل في أسماءٍ كبيرة من مبدعيها، وفي مقرها الثقافي الكبير (بيت درنة الثقافي) وما يحويه من كنوز، هي ميراث هذه المدينة على مدى أجيال متعاقبة، ومن ذهاب مبنى (جمعية الهيلع) بما تحويه من كنوز تاريخية والشواهد الجيولوجية والآثار التي تحويها، ذهبت كلها إلى البحر واستقرت هناك، وأيضاً مباني السينما التي اشتهرت بها المدينة، ومبنى المسرح الذي يعد أولى لبنات المسرح في بلادنا.
وتضيف المتحدثة ذاتها أن الزمن كفيلٌ بجراح الناس وخاصة المبدعين منهم، فالشباب يسعون للتوثيق وترميم الذات ومحاولة العودة ولو بعد حين. وتفيد الأديبة بظهور بعض الكتب المهمة لتأريخ وتوثيق ما جرى.
دعم نفسي
وفي أهوال الفاجعة واستفحال مشاعر الكرب والفقد والصدمة، تقدمَ جانب الدعم النفسي الذي لطالما وصمّ بالعار محاولاً فرض نفسه، إذ تقول فوزية بن غشير عضو مجلس الإدارة بالهيئة الوطنية للصحة والدعم النفسي والاجتماعي إن قرابة 2500 شخص من الأهالي ترددوا على 12 مركزا وعيادة نفسية في درنة، يعمل بها 18 طبيبًا نفسيًا و6 ممرضين، معتبرةً أن هذا الرقم جيد مقارنةً مع نظرة المجتمع الليبي لمسألة تلقي العلاج النفسي.
وعن الفئات الأكثر تضررًا، رصدت هيئة الصحة حالات اضطراب نفسي لدى الأطفال، تمثلت في الصمت المطبق وعدم القدرة على الكلام، والتبول اللاإرادي، فضلاً عن تكوّن فوبيا ضد المياه.
وأكدت بن غشير عدم تسجيل أي حالات انتحار فعلية، عدا تسجيل بعض المحاولات التي باءت بالفشل بين شريحة الشباب التي تعاني من الاكتئاب والعزلة بحسب ما وثّقته الهيئة.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وعمليات إدماج الأطفال بالمجتمع ومحاولة رصد أي سلوكيات نفسية ناجمة عن الصدمة، تنضوي تحت برامج هيئة الصحة نواد صحية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال تحت شعار “بالأمل نتحدى الألم” التي تستهدف 9300 طفل، ويقدم الخدمات في تلك النوادي 500 شخص، و75 طبيبًا متخصصًا في الصحة العامة والنفسية.

تحذير غير كامل
العلاقة بين العلم وصُناع القرار حتمية تكاملية توظّف الأدلة العلمية وتحليل البيانات لتوجيه قرارات صُناع القرار لصياغة سياسات الاستجابة للتحديات، لكن الوضع في درنة كان عكس ذلك تمامًا، إذ ألقى عطية الحصادي رئيس مجلس إدارة مؤسسة “رؤية” لعلوم الفضاء -وهو ناشط في مجال المُناخ- باللائمة على المركز الوطني للأرصاد الجوية، معتبرًا أن التقصير “الأعظم” صدر عن هذا المركز الذي تعامل مع اضطراب الطقس -برعونة- على حد تعبيره، وقصوره في تقدير الموقف بشكل جيد، فبدلاً من إطلاق التحذيرات اللازمة ليتسنى للدولة التحرك ومجابهة هذه العاصفة، اكتفى بالتحذير من مستوى الأمطار الغزيرة فقط، ومن هذا المنطلق لن تستطيع لوم أي صانع القرار، وفق قوله.
وتجنبًا لحدوث مثل هذه الكوارث مستقبلاً، أوصى الحصادي بعدم الاعتماد مع مركز الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى تشكيل هيئة -جسم واحد- خاصة بالاستجابة والطوارئ تعمل على إطلاق التحذيرات المناخية، وتخاطب الجهات الحكومية وتقوم بوضع خطط الطوارئ والتدخل السريع وتزوّد بالإمكانات اللازمة، بما في ذلك الأجهزة والمختصون بالتدريب والتنسيق وفرق الإنقاذ.

تعاظم الفقد
رغم ثقل الخسارة وفداحة الفقد، يقول حمدي بالعيد -وهو ناشط مدني ومتطوع بالهلال الأحمر، كان قد فقد أسرته المكونة من 5 أفراد أثناء تأديته واجبه التطوعي جراء ابتلاع السيل لحيّهم السكني بالكامل- إن ما حدث “أعظم من أنْ أتمكن من وصفه، في تلك الليلة، كنت أقوم بعملي ضمن فرق الإنقاذ والانتشال في جمعية الهلال الأحمر، وكنت مطمئنًا كون أسرتي تعيش في منطقة مرتفعة مقارنةً بباقي المناطق. لكن الصدمة كانت لحظة إدراكي أن السيول ابتلعت منزلنا والحي الذي كنت أمكث فيه بالكامل، وكان حجم الدمار والجثث طاغيًا على المشهد، ولأنني متأكد بأنّ عائلتي لن تغادر المنزل تحت أي ظروف أدركت أنهم ذهبوا مع السيل”.
بعد 3 أيام من البحث المُضني وفقدان الأمل من التعرف على جثامين عائلته، أخذ بلعيد على عاتقه مسؤولية مساعدة المتضررين في البحث عن ذويهم. وبعد مرور عام كامل من الفقد والثكل، لا تفارقه ذكرى أقربائه، لكنه يشق طريقه متصالحا مع ألمه راضيا بالقدر.
كل مفقود ميت
في ظلِ غياب إحصائية -حقيقية- عن أعداد ضحايا السيل، لماذا تتمسكُ السلطات الليبية بعدد الضحايا البالغ 4540 شخصًا، في حين تشير التقديرات الدولية إلى أن عددهم يفوق 11 ألف شخص.
وجوابا عن سؤال الصعوبات التي تُواجه الجهات التشريعية في تحديد هويات المفقودين، يقول أستاذ القانون الخاص راقي المسماري إنه جرى تقسيم الوفيات إلى شقين، الأول وفيات تمّ دفنها، والثاني ضحايا مفقودين.
وأشار إلى قرار مجلس النواب الليبي القاضي بعدم انتظار الضحايا من ذوي المفقودين حتى 3 سنوات ليحكم بالموت الغيابي على ذويهم، بل بإمكان ذوي الضحايا الذهاب لمحكمة درنة والإبلاغ عن المفقود بموجب المستندات التي منحتها إيّاهم محكمة النيابة العامة التي تنص على أن كل ضحية فُقد بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول في درنة يعتبر ميتًا لأن “الفقد يغلب عليه تبعة الهلاك” على حد قوله.
وفي المحصلة، ومع انقضاء عامٍ كامل على هذه الفاجعة يتساءل الليبيون “هل أسلبنا دانيال جزءًا إضافيًا متغاضى عنه من حقوقنا التي نؤمن بها؟ تلك التي تُطاردنا في صحونا ومنامنا؟ أم أنهُ أحيا فينا إنسانيتنا التي سلبتها حروب ونزاعات وهمية لم نُنْشئها ولم نشأها؟”.
ورغم هذا وذاك، تبقى درنة -كما يصفها سكانها وكل الليبيين- مدينة الثقافة والياسمين والزهر والحنّة.